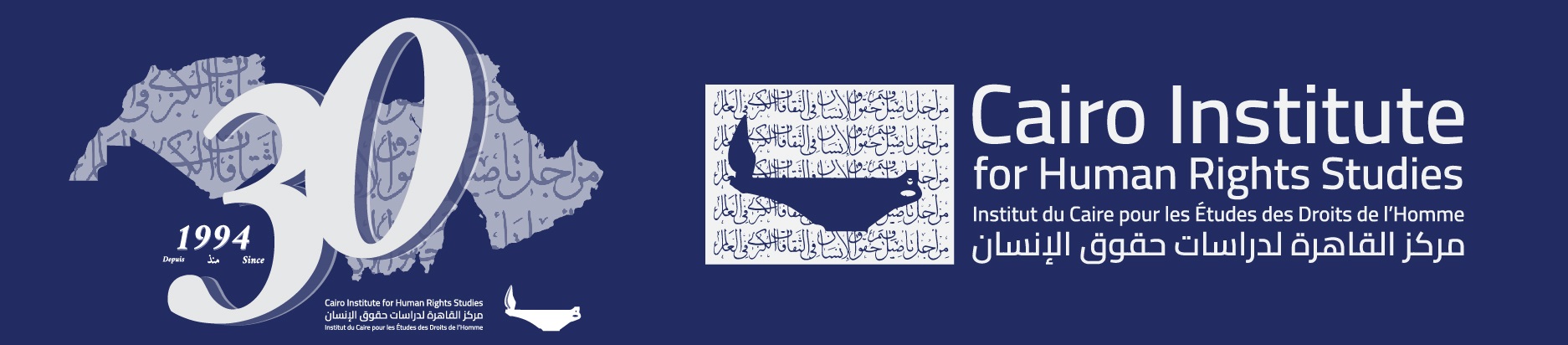بهي الدين حسن
ما حدث في الإسكندرية هو نتيجة تراكم تدريجي بدأ مع يوليو ١٩٥٢، واستئصال السياسة وكل نشاط مدني مستقل من المجتمع، بحيث صار المصري تدريجياً يعبر عن هويته من خلال الدين. وصارت المؤسسة الدينية «مسيحية أو إسلامية» هي أقوي الأحزاب في مصر، ولا ينافسها في ذلك سوي الأهلي والزمالك.
منذ ٣٥ عاماً والأحداث الطائفية تتواتر في مصر، وبلغت ذورتها بمذبحتي ديروط والكشح اللتين سقط قتيلاً فيهما نحو ٣٠ قبطيا، ولكننا مع أحداث الإسكندرية الأولي منذ شهور، والثانية منذ أيام، انتقلنا لمرحلة اشتباك الكتل البشرية الطائفية، رافعة لواء المصحف في مواجهة الصليب.. وما لم تتوقف الحكومة وبرلمانها وإعلامها عن دفن الرؤوس في الرمال، واتهام كل الأطراف «من الموساد والأصابع الأجنبية إلي المتطرفين والمخبولين» باستثنائها هي، فإننا نسير بخطي ثابتة مهما كانت بطيئة علي طريق العراق ولبنان.
الحكومة «تستعبط» عند كل كارثة طائفية عندما تسأل عن الحل، بينما روشتة الحل في أدراج مكاتبها منذ عدة عقود، وما يتطوع به المفكرون والكتاب ومنظمات حقوق الإنسان عند كل كارثة طائفية، هو مجرد استدعاء ما طالبوا به هم أو آباؤهم من قبل. لا حاجة بنا لمطالعة ما تصرح به الحكومة وبرلمانها حول الأحداث الأخيرة، يكفينا الرجوع للأرشيف الصحفي علي مدار عدة عقود مضت، وأعوام أخري قادمة.. إنه نفس خطاب النعامة، حتى إن التقرير الوحيد الجاد الذي تغلغل في أعماق المشكلة، جري دفنه منذ ٣٤ عاماً. إن المهمة الأولي للجنة تقصي الحقائق البرلمانية الجديدة، هي أن تنتشل تقرير لجنة جمال العطيفي من سلة مهملات الحكومة والبرلمان، وإما سيلتحق تقريرها به.
لم يعد ممكنا استمرار التهرب من مواجهة الحقيقة المرة، وهي أن مصر تغوص بالفعل في مستنقع طائفي، ارتكز في البداية علي أدوات قانونية وإدارية وسياسات غير معلنة، وانتهي بهيمنة خطاب ثقافي وسياسي وإعلامي طائفي، يتشربه المسلمون والمسيحيون كل يوم، ويتخذون بناء عليه ردود أفعال واعية ولا واعية، يومية، كل من موقعه الطائفي الخاص، بينما فقد خطاب المواطنة أرضيته وتحول إلي جملة إنشائية فارغة يرددها المثقفون المعزولون، ذلك لأن أسس المواطنة تآكلت بالفعل، وحلت محلها علاقات مؤسساتية وخطاب يكرس الطابع الطائفي، وترسخت تصورات جديدة لكل طرف عن الآخر، حتي صار المسيحيون في مخيلة كثير من المسلمين، رمزاً وامتداداً للأجنبي الذي اغتصب المسلمات في البوسنة وكوسوفا، ويسعي لتحوير دينهم في مصر، والسخرية من رسوله في الدنمارك وغيرها.
يجب أن نلاحظ أن «القاتل» في الأحداث الأخيرة كان يهتف وهو شاهر سيفه «فداك يا رسول الله»، وهو الهتاف الذي سبق أن ردده الألوف ممن يصعب نعتهم بـ«الخبل أو الجنون»، بينما صارت صورة المسلمين في مخيلة كثير من المسيحيين، أنهم مستبدون يستأسدون بأغلبيتهم وحكومتها عليهم وعلي دينهم، إلي حد إباحة التدخل لفرض تصورات «إسلامية» ـ ليست محل إجماع المسلمين ـ علي كيفية تعامل القبطي مع دينه، في الزواج والطلاق والميراث وغيرها، وأخيرا حقه في أن يجسد المسيح في أفلام ومسلسلات فنية!
أرجوك يا أبي.. لا أريد أن أكون مسيحياً!
سأحدثكم عن قصة واقعية، إنها عن إحدى الأسر القبطية التي أعرفها، وربما تعرفونها ولن أفصّل، فالتفاصيل لن تهم، لأن المقصود هو الظاهرة وليس الاستثناء.
الأسرة تنتمي للشريحة العليا في الطبقة الوسطي، الأب والأم علمانيان، لا يترددان علي الكنيسة إلا في المناسبات الاجتماعية لأقاربهم وأصدقائهم الحميمين، مناسبات مثل الزواج والوفاة.
الأولاد بدأوا يكبرون، الأكبر يدرك ويترسخ لديه شعور عميق بأنه مختلف عن أغلبية زملائه وزميلاته في المدرسة، غير أن الشعور بالاختلاف يتلاشي تدريجياً ليحل محله شعور بالدونية، فهو ليس مختلفا عن الأغلبية فحسب، ولكنه ينتمي إلي فئة أقل شأنًا في المجتمع، فهو يتلق طوال اليوم الدراسي معلومات متنوعة عن دين الفئة الأعلى شأنًا، أي الإسلام من خلال دروس اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا وغيرها، ومن خلالها يعرف أمجاد هؤلاء الذين اتبعوا هذا الدين الآخر، سواء كانوا أنبياءً أو ملوكًا أو أدباءً أو شعراءً أو قادة عسكريين، وهم جميعًا دون أي عيوب، هم أقرب للملائكة منهم للبشر. أما الفئة التي ينتمي إليها فلا يعثر لها علي أثر لا في التاريخ ولا اللغة العربية أو الجغرافيا، إلا ربما في صورة المستعمرين الأشرار، أو المبهورين بالإسلام المتحولين إليه أفواجًا أفواجا. إنه لا يعرف عن دينه شيئًا إلا من خلال الحصة اليتيمة للدين، ذلك إذا حضر المدرس، فالتلاميذ الأقباط قليلون وكذلك المدرسون الأقباط، لذا فالمدرس يأتي خصيصًا من مدرسة مجاورة.
في أحد الأيام، فاجأ التلميذ أباه بسؤال بريء: لماذا لا يرى الأقباط في التليفزيون؟، تلعثم الأب قليلاً وارتبك، ليس لأنه لا يعرف الإجابة، ولكن لأنه يعرفها، ويعرف ما هو أكثر! كان الارتباك لأنه لم يكن يتوقع أن يتوصل ابنه إلي هذا الاستنتاج/السؤال في هذا العمر المبكر.
قرر الأب أن يهرب من السؤال بسؤال آخر: كيف عرفت هذا؟ فقال: إن الأسماء التي تتردد كل يوم في التليفزيون هي لمسلمات ومسلمين، لمذيعين ومذيعات، ممثلين وممثلات في المسلسلات والأفلام، والشيوخ الذين يتحدثون قبل نشرة التاسعة مساء، ومقدمو ومقدمات البرامج والضيوف الذين تتم استضافتهم في هذه البرامج!
ليس مهمًا كيف أجاب الأب بعد ذلك، أو كيف انتهي هذا الحوار، لأنه في واقع الأمر لم ينته، بل تواصل وتكرر كل يوم تقريباً، حتى جاء يوم، صارح فيه الابن أباه وأمه بأنه لا يستطيع أن يتحمل أن يعيش قبطيًا أكثر من ذلك، وأنه يريد أن يصير مسلمًا، بل ويطلب منهم مساعدته لتحقيق ذلك!
كأسرة علمانية، لم تكن لديها مشكلة في أن يصير ابنهم مسلمًا، ولكن كان مصدر قلقهم أن الاختيار الجديد للابن ليس اختيارًا حرًا، بل هو وليد ضغوط نفسية هائلة، وليس فقط لقلة معرفته بدين أسرته، ولكن الأهم نتيجة عملية منهجية يومية للتجهيل بدينه والحط منه، وتعميق الشعور بالدونية.
ولذا كان القرار الأول للأسرة العلمانية التي لا تعرف الطريق للكنيسة، هو أن تتردد بشكل منتظم علي الكنيسة «بالتبادل أسبوع للأب، والثاني للأم» حتى يتيحا الفرصة لابنهما ـ بل لأبنائهما الأصغر أيضًا ـ لمعرفة دينهم، قبل أن يقرر أو يقرروا جميعًا استبدال دينهم بالإسلام.
إذا كان ذلك هو مآل أسرة من الشريحة العليا في الطبقة الوسطي، فلنا أن نتخيل كيف هو حال الأسر المسيحية الفقيرة، التي نقرأ كل يوم عن اختفاء وظهور مفاجئ لبناتهن بعد أن أسلمن؟
في هذا المجتمع الأحادي الذي لا يعترف عمليًا سوي بالرأي الواحد والفكر الواحد والحزب الواحد والدين الواحد «بل والمذهب السني الواحد»، يعيش الأقباط معاناتهم الخاصة، قد تختلف صور المعاناة، لكن مصدرها واحد، وهو عدم الاعتراف الفعلي بهم كمواطنين يتمتعون علي قدم المساواة مع المسلمين بكل حقوق المواطنة، بغض النظر عن دينهم.
ربما يقول الدستور والقانون وخطب وأحاديث المسئولين بالمساواة، ولكن الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والديني لا يقول بذلك بل يقول بعكس ذلك تمامًا. الضمانات الدستورية والقانونية شرط أساسي بالطبع، ولكن هذه الضمانات ما لم تترجم في الواقع المعاش إلي حقائق يومية مادية ملموسة، فإنها تفقد قيمتها إلا بالنسبة لبعض الباحثين المكتبيين والمؤرخين.
واقع الحال يقول إن الأقباط ليسوا مواطنين علي نفس الدرجة أو الرتبة المصروفة للمسلمين، إنهم يخضعون عند بناء الكنائس لشروط خاصة لا يخضع لها المسلمون عند بناء المساجد، إنهم لا يتولون المناصب الكبرى كالوزارات السيادية وغيرها، لقد كان ممكنًا لبطرس غالي أن يصير سكرتير عام الأمم المتحدة، أي وزير خارجية العالم بمعني ما، ولكنه كان من المستحيل أن يعين وزيرًا للخارجية مصر! وبينما تقبل جامعة الأزهر طلابًا من نحو ٦٠ دولة أجنبية، فإنها لا تستطيع أن تقبل طالبًا واحدًا قبطيًا مصريًا، رغم أن الضريبة التي تدفعها أسرته للدولة المصرية، تستخدم في الإنفاق على هذه الجامعة وعلى الطلاب غير المصريين فيها!
يغذي هذا الوضع السياسي الإعلامي التعليمي الديني الطائفي الشعور بالدونية لدى الأقباط، وفي المقابل يغذي لدى بسطاء المسلمين الشعور بالاستعلاء إزاءهم، والاستعداد للنزوع للعنف علي ما قد يعتبرونه تجاوزًا للوضع الدوني المكرس، أو محاولة للتملص منه أو الاحتجاج عليه.
آن الأوان أن يبادر المثقفون والكتاب بتبرئة أنفسهم وذمة أغلبية المصريين من المسؤولية عن القاع السحيق الذي تهوي إليه البلاد دون أي فرامل، ويستبدلون الوصفات الإنشائية، مقطوعة الدلالة، بالواقع المر «حول وحدة وتماسك النسيج الوطني والوحدة الوطنية والمواطنة»، بموقف جماعي علني واضح يرفض كل المرتكزات القانونية والسياسية والإدارية والأمنية والدينية للتمييز الطائفي، ويطالب بإسقاطها الفوري، ويرفض أن يلصق بالمسلمين عار القبول والتمتع بأي تمييز لهم علي مواطنيهم المسيحيين، ويطالب بإعمال المساواة الكاملة الفورية، ورفع وصاية المؤسسات الدينية ـ إسلامية ومسيحية ـ علي مجالات السياسة والفكر والإبداع.
فهل لدينا مائة مثقف مسلم يعلنون للشعب المصري والعالم أن ما يحدث ليس باسمنا ولا نقره، ولا نقبل التعايش معه بعد اليوم؟!
نشر هذا المقال في جريدة المصري اليوم
Share this Post